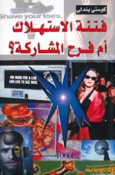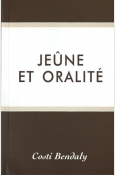نضال عنفي او لاعنفي لاحقاق العدالة
“الإنجيل على دروب العصر”- منشورات النور – الطبعة الأولى- 1988
ملخص
سؤال الشباب يتركّز كما هو ظاهر على موضوعين: موضوع العدالة وموضوع العنف، وعلى الارتباط بينهما. فقضية العدالة والتحرّر وحقوق الإنسان على أشكالها وضرورة النضال من أجل إحقاق ذلك كلّه، قضية تحتل مكانة مميزة في عالم اليوم الذي كثيرًا ما يعكس الشباب هواجسه. وإنّهم يلاحظون ولا شك أن الوجه الأبرز الذي يتخذه النضال من أجل العدالة، أو بالأحرى الوجه الذي يغلب ظهوره لهم عبر وسائل الإعلام، إنّما هو الوجه العنفي، من عمليات مسلحة وحروب تحرير وأعمال إرهابية. ويُهيَّأ لي أنه قد بدا لهم وكأن هناك تلازمًا بين النضال العنفيّ وبين إحقاق العدالة. ولا يغيب عن البال أن السؤال طُرح، كما سبقت الإشارة، سنة 1981، أي في وقت كانت الحرب اللبنانية مستمرة فيه منذ ستة أعوام. ولا بدّ أن الشباب طارحي السؤال كانوا يلاحظون أن الفئات المسلحة المتصارعة آنذاك “على الساحة اللبنانية” كانت تقول كلها بالنضال المسلح طريقًا إلى الحقوق المشروعة التي تقتضيها العدالة.ولا بدّ أن هذا الارتباط الراهن بين الدعوة إلى العدالة واعتماد العنف وسيلة لها، قد أثار تساؤلاً وجدانيًا لدى الشباب نابعًا من قناعاتهم الإيمانية. فهم يفهمون أن الانجيل يدعو إلى العدالة من جهة وإلى السلام من جهة أخرى. وكان لا بدّ لهم بالتالي أن يتساءلوا عن كيفية التوفيق بين هذه الدعوة وتلك. من هنا السؤال الذي طرحوه والذي انطلقت منه هذه الدراسة...

تعليم الفتاة وآفاق المرأة- “تساؤلات الشباب” 4
تعليق على استقصاء بين الشباب
جرّوس برسّ – الطبعة الثانية – 1998
ملخص
هكذا ينطلق عملنا من عرض حصيلة استقصاء بين الشباب حول تعليم الفتاة ليتطرق، عبر تحليل مواقفهم وتصوراتهم، إلى طرح شامل لقضية المرأة كما هي مطروحة بحدة في عالم اليوم. هذا ولم نشأ أن نقتصر، في معالجة هذه القضية، على عرض لحاضر المرأة الملتبس المتأزم، بل شئنا أن نتبنى نظرة الشباب، المتوثبة بطبيعتها نحو الآتي، فتحدثنا عن “آفاق المرأة “متطلعين إلى مستقبل أفضل حري بأن يجاهد من أجله كل المخلصين، نساءً كانوا أو رجالاً، مستقبل يتحقق فيه للمرأة ملء كرامتها الإنسانية وكامل حجمها الإنساني، لا باللفظ وحسب – وما أبرع الإنسان في تسخيره، عن قصد أو غير قصد، من أجل التعمية والتمويه – ” بل بالعمل وحقاً “. إن ذلك التحول المرتجى أمر واجب وملحّ، لا إنصافاً للمرأة وحسب، بل لصالح الرجال أنفسهم الذين لن يبلغوا ملء قامتهم الإنسانية ولن يحققوا ما يصبون إليه من انتعاش ورضى إلا إذا نظروا إلى المرأة نظرة الند للند واعتبروها، لا أداة لأغراضهم، بل شريكة في مصيرهم، ولصالح المجتمع البشري برمته الذي هو بأمس الحاجة، لكي ينمو بشكل سليم متكامل متزن وينجو من تشنجاته وانحرافاته التي باتت تهدده بأفدح الأخطار، إلى إطلاق الطاقات المقيدة لنصفه النسائي وتوظيفها كما ونوعاً في عملية إصلاحه وإنقاذه.
طبعات أخرى
منشورات النور – الطبعة الأولى 1985...

الزواج: درب الحُبّ ومختبرُه - الأبعاد النفسية والروحية للزواج والأسرة
دار زخور - حلبا - الطبعة الثانية - 1999
ملخص
هذا الكتاب، الذي صدر، في طبعته الأولى، سنة 1982، عن منشورات النور (بيروت)، يصدر الآن في طبعة ثانية موسّعة.لقد أردناه، في الأساس، – وكما يشير عنوانه الأصلي “صورة المسيح في الزواج والأسرة” – تعبيرًا عن رؤية روحيّة، إيمانيّة، لهذين الواقعين الإنسانيين، ومن أجل توضيح هذه الرؤية، استلهمنا الكتاب المقدس والتقليد الآبائي والليتورجي، وأعمال اللاهوتيين ممّن ينتسبون إلى الأرثوذكسية أو إلى المذاهب المسيحية الأخرى، يجمع بين هؤلاء وأولئك، ذلك التراث الواحد غير المنقسم، الذي هو الأصل، والذي ينهد إليه اليوم المسيحيون ليتجاوزوا به انقساماتهم.
طبعات أخرى:
منشورات النور- الطبعة الأولى – 1983
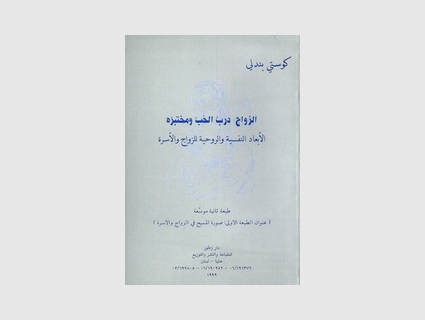
موقف إيماني من الطائفية
الكتاب، في جوهره، نقد للطائفية من زاوية التديّن الذي نراه أصيلاّ. وخلاصته أنّ "الطائفيّة تزول اذا عاد الدين الى الطوائف"، كما قال أحد مؤسّسي حركة الشبيبة الأورثوذكسيّة في أوائل الأربعينات من القرن الماضي.والآن نشهد في لبنان عودة للدين في كلّ الطوائف. فدور العبادة تنتشر وتتكاثر. وهي تمتلىء بالمصلّين عندما تقام فيها الشعائر، وإن كانت نسبة المواظبين بانتظام على ممارسة تلك الشعائر لا تزال ضئيلة على ما يبدو (وفي غياب الإحصاءات الدقيقة، التي نفتقدها، في حين أنّها شائعة في الغرب). وقد تزايد عدد رجال الدين المتعلّمين، وكثرت المنشورات الدينيّة، وظهرت محطّات إذاعة وتلفزيون تنطق باسم الأديان، وتكاثرت المدراس التابعة للجماعات الدينيّة، وتوزعت بين هذه الجماعات المؤسّسات الجامعيّة التي قفز عددها في لبنان الى رقم قياسيّ.الدين يعود إذاً ، وهذا أمر ايجابيّ مبدئيًّا، ولكنّه لا يغني عن التساؤل: أيّ دين هذا؟ أيّ نوع من التدين؟

الجنس ومعناه الإنساني
يدور هذا البحث حول مناقبيّة الجنس،(…) مناقبيّة الجنس في منظار كهذا، هي أن يحقق الجنس مرماه الإنساني. لذا لا يمكن تحديدها بالاستقلال عن دراسة الجنس كما يتجلى عند الإنسان. هذا لا يعني أنه من الممكن تحديد هذه المناقبيّة عن طريق الاستنتاج العلمي البحت. فالعلم، من حيث هو علم، يصف ما هو كائن وليس من شأنه أن يحدد ما ينبغي أن يكون. عالم القيم خارج عن متناوله. لذا فالبحث في مناقبيّة الجنس يفترض تقييماً للجنس مرتبطاً بنظرة شاملة إلى الإنسان ومعنى وجوده. ولكن لا بد لهذا التقييم، إذا شاء أن يكون متأصلاً في مقتضيات الكيان الإنساني، أن يتخذ معطيات علوم الإنسان منطلقاً له، حتى لا يكون المعنى الذي يضفيه على الجنس غريباً عنه بل نابعاً من صميمه.هذا ما سنحاول تحقيقه.
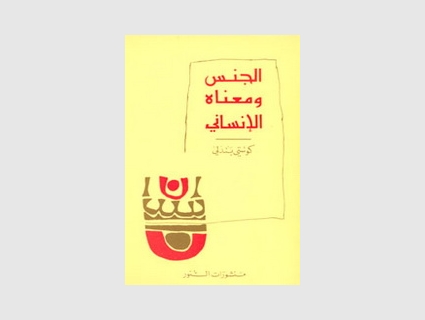
عناد الولد وسلطة الوالدين– “نحن وأولادنا”-الجزء الثاني
- "ذكيّ وعصبيّ، ورش وعنيد".
- "مشكلتنا أنّ ابنتنا عنيدة ولا تسمع الكلام من أوّل مرّة. فلماذا؟"
كم من مرّة صدرت عنّا هذه التساؤلات؟ كيف يُمكن معالجة الطفل العنيد وهل يجب أن نعاكسه، أم نتركه يفعل ما يريد؟
العناد سلوك يعبّر عن نزعة عند الولد إلى مخالفة الوالدين وتأكيد مواقف له ... العناد مزعج في أغلب الأوقات، إنّما له دور إنمائي ذو وجهان: تأكيد لتمايز الشخصيّة النامية واختبار لقدراتها الناشئة.
لكن قد يتّخذ العناد شكلاً مفرطاً، إن من جهة حدّته، أو من حيث امتداده الزمنيّ. في هذه الحال ينبغي لنا، بدل التركيز على هذه الظاهرة بحدّ ذاتها، أن نُدرك أن ولدنا إنّما يتّخذها لغةً يعبّر بها عن ضيقٍ ما يعاني منه. ومن أجل ألّا تتحوّل رعاية الوالدين للأولاد إلى تحكّم من القوي بالضعيف الذي يؤدّي إلى العناد بشكل شبه حتميّ كدفاع مستميت يمارسه الولد عن كيانه الشخصيّ، بنبغي لسلطتنا الوالديّة أن تتقيّد بشروط أساسيّة، ومنها: أن نمتنع عن الإفراط في إصدار الأوامر، أن نأخذ بعين الاعتبار إمكانيّات الولد وفقًا لمرحلة عمره، بالإضافة إلى شروط أخرى يفصّلها الكاتب في كتابه القيّم هذا.
إنّ موضوع العناد، كما وأية مشكلة تربويّة أخرى، لا يعني الولد وحسب، إنّما هو يعني في الصميم تلك العلاقة القائمة بيننا وبين ولدنا. من هنا يستدرجنا موضوع العناد، وبشكلٍ طبيعيّ، إلى مواجهة موضوع نمط علاقتنا بأولادنا على وجه العموم، وبشكلٍ أخصّ موضوع نوعيّة السلطة التي نمارسها حيالهم!
كل هذا يقودنا إلى السؤال الأساسيّ الذي عبّر عنه الكاتب في خلاصة الكتاب: "هل أنّني أعامل فعلاً أولادي وفلذات كبدي، على حبّي الكبير لهم، هل أعاملهم كما أودّ أنا أن أُعامَل من حيث المراعاة والاعتبار والكرامة؟"
هذه المجموعة، المنطلقة من تساؤلات الأهل، تحاول أن تقدم لهم جوابًا مقنعًا وشافيًا عن هواجسهم التربوية، مستندًا إلى خبرة المؤلف كوالد ومرشد تربويّ وإلى تخصّصه النفسي. إنها تسلّط الضوء على طبيعة المواقف التي يتخذها الوالدون تلقائيًا في سياق حياة الأسرة، والتي تؤثّر سلبيًا، من حيث لا يدرون أحيانًا، في سلوك أطفالهم، وذلك بغ...

من يستطيع أن يتكلّم على سيرة هذا الرّجل؟ من يستطيع أن يتكلّم على كوستي بندلي؟ هذا المُربّي بكلِّ معنى الكلمة، هو المُعلّم لا بل الأب. كثيرون يتكلّمون على الكهنوت الملوكي لكن قليلون يعيشونه، كان هو الكاهنَ بامتياز. لماذا؟لأنّه كان صادقاً، إيمانُهُ كان حياتَهُ. هو المُصلّي.. هو الباحث.. لقد جمع بين العقل والقلب.. تكلّم على الأطفال لأنّه كان يحسّ معهم.. تكلّم على الشّباب لأنّه كان يعيش معهم.. لكن كيف عرف كلّ ذلك؟ كيف تممّم كلّ ذلك الإرث الضّخم الذي تَركهُ؟ أنا أقول لكم كيف: لقد حصل على نِعَمِ الله الغزيرة، لأنّه اكتسب فضيلةَ التّواضع. الكلّ يَشهدُ كيف تصرّف في الحرب الأهليّة..ويَعرفُ كيف حَرِصَ أن يبقى في بلدهِ في الأوقات العصيبة.. الكثيرون يعرفون كيف كان يعملُ عَمَلَ راعٍ في رعيّته. هو الذي أنشأ نظامَ الاِشتراكاتِ في الرّعيّة.. هو الذي شجّع السَّهراتِ والإجتماعاتِ الإنجيليّة.. كان أميناً لربِّه حتى النّهاية، مُنكبّاً على الدّراسة، ومُنكبّاً على العمل، مُجاهداً في ما بين شَعبهِ. أين الذين
يُنادون بالعيشِ المُشتَرك؟ خُذُوا هذا الرَّجُلَ مِثالاً.
المطران أفرام كرياكوس
المطران أفرام كرياكوس
القيت هذه الكلمة في لقاء اقامه فرع الميناء لحركة الشبيبة الارثوذكسية في ١ اذار ٢٠١٤
في إحدى حصص علم النفس، أخرج ورقة بيضاء، ولطّخ نصفها بالحبر عشوائيًّا، ثمّ طواها فانطبع على نصفها الثاني الشكل الذي اتّخذه مسيل الحبر. ثمّ راح يعرضها بحالتها الجديدة على الطلاب، ويسألهم عمّا توحي به إليهم، حتّى إذا وصل إليّ، سألني بصوته الودود:
Qu’est-ce que vous inspire cette figure?
:فأجبته
Deux formes symétriques
:فامتعض... وقلّما كان يمتعض... وعلّق، بتهذيب شديد
:بيان صادر عن بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس
أيها الصالح. لقد أمتّ الموت وأبدت الجحيم بدفنك ذي الثلاثة الأيام. ولما نهضْتَ كما يليق بالله. أنبعتَ الحياة للذين في العالم يا يسوع ملكي” (من الخدمة الليتورجية الأرثوذكسية ليوم 12 كانون الأول)
كوستي بندلي الذي تودعه كنيسة أنطاكية اليوم على رجاء القيامة هو واحدٌ
كتابات كوستي بندلي: إنسانيّتها، عمقها وروحانيّتها
حصل لقائي مع الأخ كوستي بندلي على صورتين متوازيتين. جاء لقائي الأوّل معه في مؤتمرٍ لمسؤولي طفولة حركة الشبيبة الأرثوذكسيّة في صيف 1949، فرأيته إنساناً طيّباً وديعاً متواضعاً، وكان كلُّ واحد من المشاركين في ذاك المؤتمر يشعر بأنَّ الأخ كوستي قريب منه. وانتهى اللقاء وكلٌّ منَّا يشعر بأنه استفاد من كلام الأخ كوستي ومن مواقف محبّته للجميع. وتوالت السنون، وكنتُ ألتقي به بين الحين والآخر. وكلَّما التقيته، ازداد إعجابي بهدوئه ورصانته وتواضعه.
وجاء لقائي الآخر به من خلال كتاباته المتنوِّعة المفيدة، وما عسى المرء يقول فيها! عندما يقرأ الإنسان كتابات الأخ كوستي بندلي الشاملة، من حيث تناولها العالمين النفسيّ والتربويّ الأخلاقيّ، تستوقفه ثلاث محطّات بالغة الأهمّيّة والأصالة من وجهة النظر المسيحيّة
القيت هذه الكلمة في لقاء اقامه فرع الميناء لحركة الشبيبة الارثوذكسية في ١ اذار ٢٠١٤
نجتمع اليوم لذكرى كوستي الحبيب، ولنسترجع معًا بعض ما اختبرناه معه من حياة.
نجتمع اليوم، لنستعيد بعضًا ممّا عكسته حياة كوستي علينا من نور.
نجتمع اليوم أيضًا، كيلا ننسى وعدنا الصعب له ... وعدنا الصعب لك يا كوستي. ذاك الوعد الذي قطعناه، أمام أنفسنا وأمام الله، بأن نبقى نتحرّك وأن نحافظ على الحركة فينا، وأن نبقى منحازين للحياة والحقّ وسالكين الطريق.
صديقي الحبيب كوستي، في الحقيقة أنا أخجل من أن أتحدّث عنك، فأنا على يقين أنّني مهما قلت لن أفيك القليل من محبّتك وجمالك وصداقتك.
صديقي، أنا أخجل من أن أتكلّم عليك بعد أن أمضينا أيّامًا طويلةً لا نتكلّم ... ولكن
القيت هذه الكلمة في لقاء اقامه فرع الميناء لحركة الشبيبة الارثوذكسية في ١ اذار ٢٠١٤
ماذا تقول حركة الشبيبة الأرثوذكسيّة في كوستي بندلي اليوم؟
وقبل أن أستمع إليها أتوجّه إلى راحلنا العزيز وأقول له: «عذرًا لأنّني ها أنا فاعل، في كلامي فيك، ما لم ترده في حياتك كلّها، ولم تسمح به سحابة عمرك. فعذرًا وألف عذر».
أنا لا أمدحك ولكن أقف لأتعلّم منك. جئناك اليوم، كعادتنا، لنستمع إلى حديثك الباني، كما كنّا نقصدك حاملين إليك الهواجس والمسائل لنغرف من معين علمك الغزير وفيض إخلاصك الكبير.
لمّا تتحدّث الحركة عن العزيز الراقد تتحدّث عن ذاتها وتبوح ببعض من جوهرها، بقدر ما تسعف اللغة، الحركة حالة وحياة نعرفها بالذوق، بالقلب والوجدان والخبرة.
فعسى، أيّها الراحل المقيم والغائب الحاضر، أن أنجح
كوستي بندلي: كتاب … بأقلام الشّباب
الدكتور جان عبدالله توما
قد يكون من الصعب أن تقرأ كوستي بندلي دون العودة إلى حضوره الشخصيّ في حياة الشباب والاستماع إليهم، في مشاكلهم وقضاياهم، بإصغاء قد لا يتوافر لكثيرين. ولعلّ كوستي بندلي يملك القدرة على الصّبر والأناة في حواراته مع الشّباب متجاوبًا مع معاناتـهم في تركيز واضح على رغبته في ألاّ يكسر أغصانـهم الفتيّة، بل يعمل على تشذيبها بأناة وتواضع.
ربّما استمع كوستي بندلي إلى مئات، بل آلاف من الشباب يبسطون أمامه مأزقهم اليوميّ، في تعاملهم مع "السّلطة" الأبويّة منها أو الأمويّة أو المدرسيّة، أو توتّر العلاقة بين الإخوة أو الأصدقاء. وكان هو، بالمقابل، يبسط أمامهم ما تناوله من الكتاب المقدّس وحياة يسوع الشخصيّة، وما غرفه من أمّهات الكتب باللغتين العربيّة والفرنسيّة، ليطلق الشّباب من محدوديّة منطقهم ومنطقتهم أو بلدهم أو فكرهم، إلى عولمة إيجابيّة تأخذ ما هو مفيد، وترذل ما قد يسيء إلى إنسانيّة الإنسان واستعادة دوره النّورانيّ في العلاقة السّويّة القائمة على البيان والتبيين والفهم والإفهام والوضوح والإيضاح.
من علائم الكتابة الموضوعيّة أن يترك الكاتب بينه وبين الموضوع مساحة، ليحافظ على الخطّ العلمي. ولعلّ كوستي بندلي