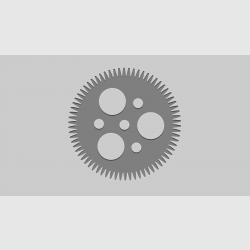أولاً: أسس الاعتقاد بأنه يُفرض بالمسيحي أن يكون بمأمن من مخافة الموت
قد يكون هذا الاعتقاد شائعاً بين الناس، كما يبدو مما يعبّرون عنه من استغراب حين يبدي إنسان ما، مشهود له بالإيمان، جزعاً حيال الموت، موته الشخصي أو موت شخص عزيز عليه. أما أسس هذا الاعتقاد، فأرى أنها كامنة في مفهوم للإيمان المسيحي يمكن تلخيصه بما يلي:
1 – اعتقاد بازدواجية الكيان الإنساني، بحيث يتكوّن الإنسان بموجب هذا المعتقد من “نفس” هي جوهر كيانه ومن “جسد” ليس سوى غلاف ترابيّ مؤقت لهذه النفس. فالموت، والحالة هذه، لا يتعدى كونه زوال “الغلاف” الجسديّ فيما تستمر النفس (وهي العنصر المهم الوحيد في الإنسان) أبدياً في حياتها.
2 – اعتقاد، مستنتج مما سبق، بأن الحياة الأرضية ليست سوى حقبة عابرة في سياق وجود لامتناهٍ، وأنها بالتالي غير جديرة بأن تؤخذ على محمل الجدّ (إلا من حيث هي مدخل إلى الآخرة) لأن امتدادها الزمني المحدود لا يُحسب له حساب إذا قيس بلانهائية الأبدية.
ثانياً: خطأ هذه الأسس ومخاطرها:
هذا ولا بدّ من التأكيد أن هذه الاعتبارات، على شيوعها، لا تثبت إذا جوبهت بالرؤية الإيمانية الأصيلة، كما أنها تشكّل خطراً يهدد سلامة الإيمان والحياة معاً.
1 – خطأ هذه الأسس
هذه الأسس باطلة لأنها تفترض ازدواجية في الكيان الإنساني تناقض فكر الكتاب والخبرة الإنسانية بآن معاً. ذلك أن كلاً من هذا الفكر وهذه الخبرة يؤكد على وحدانية الكيان الإنساني ببعديه النفسي والجسدي. فالجسد في منظورهما ليس مجرد غلاف إنما هو جزء لا يتجزأ من الكيان الإنساني الحيّ، بحيث أن المرء يعيش كل خبرة من خبرات حياته، من أدناها إلى أسماها، بهذا الكيان الموحّد وما يتضمن من بعد نفسيّ وبعد جسديّ، كما أنه يذوق الموت بكلية كيانه أيضاً بحيث يزول بفعل الموت كل النمط الأرضيّ لوجوده، بمظهريه النفسيّ والجسديّ.
2 – خطر هذه الأسس
ثم أن هذه الأسس خطرة لأنها تسيء بآن معاً إلى حقيقة الآخرة والى حقيقة الحياة الحاضرة، مشوِّهة هذه وتلك:
أ – فهي تسيء إلى حقيقة الآخرة، لأنها تتصورها امتداداً لانهائياً ومجمّلاً للحياة الحاضرة ، فتغفل بالتالي الاختلاف الكلّي والجدّة الجذرية اللذين تتميز بهما الآخرة، مسقطة عليها صور الحياة الحاضرة ورغباتها. إن الصدّوقيين، حين نصبوا للمسيح فخاً بسؤالهم الشهير عن المرأة التي تزوجت سبعة رجال على التوالي ثم ماتت، طالبين منه أن يوضح لهم لمن تكون زوجة في القيامة، أثبتوا أنهم لم يميزوا بين الآخرة، التي كانوا منكرين لها، وبين الصورة الكاريكاتورية عنها التي نحن بصددها. لذا واجههم المعلم بقوله: “ضللتم لأنكم لم تعرفوا الكتب ولا قوة الله” (راجع لوقا 20: 27 – 40).
ب – ولكنها تسيء أيضاً إلى حقيقة الحياة الحاضرة، لأنها تستهين بها وتتجاهل أهميتها، معتبرة إياها مجرد توطئة غير ذي بال، وفي آخر المطاف ضربًا من الوهم، مما يحول بين الإنسان وبين أخذ عطايا الله الأرضية له على محمل الجدّ وإعطائها كل حقها وتناولها بشكر عميق. كما أنه يعرّضه – وهذا أدهى – إلى الاستهانة بآلام الغير على أنها عابرة، والى التهاون في مكافحة أسبابها، والسكوت عن هذه الأسباب، ودعوة الناس إلى الرضوخ للأوضاع الراهنة البائسة التي يعيشونها، على أنها لا شيء إذا قيست بما سوف يناله المرء من تعويض عنها في الآخرة.
من هنا الاعتراض المحق الذي يبديه المحلّل النفسي غير المؤمن، جيرار منديل، على ما ينسبه خطأ للإيمان المسيحي (لأنه قد يكون، للأسف، شائعاً بين المسيحيين)، بأنه اعتقاد “بأن الموت وهم”، إذ يقول: “وهل تكون الحياة البشرية شيئاً آخر سوى مظهر حياة خدّاع، إذا انتزعت منها خلفية الموت؟” .
من هنا أيضاً هذا الموقف الذي شاع فيما مضى لدى الواعظين والذي يثور عليه بحق أحد أشخاص رواية شتاينبك “عناقيد الغضب”، إذ يقول:
” لقد فكّرت (…) أن كل العظات تقريباً تدور حول الفقراء والفقر. إذا كنتم لا تملكون شيئاً، فما عليكم إلا أن تضموا يديكم وأن لا تهتموا بما عدا ذلك؛ فعندما تموتون، سوف تأكلون طيوراً فاخرة في صحون من ذهب …” .
ومن هذا الباب أيضاً، ما يذكره المؤرخ المسيحي المعاصر الكبير جان دوليمو، من سكوت السلطات الدينية عن تجارة الرقيق، هذا السكوت المستند جزئياً إلى منطق بغيض، اعتُبر طيلة أجيال على انه من المسلّمات البديهية، ألا وهو أن هؤلاء الزنوج كانوا، لقاء حياة الشقاء التي يقضونها، يدخلون إلى عالم المسيحية مما يؤهلهم إلى نيل الفرح الأبديّ بعد موتهم .
ثالثاً: خطأ التصور الذي يفترض أن المسيحي بمأمن من الخوف من الموت
وبغض النظر عن خطأ الأسس التي يستند إليها الاعتقاد بأن المسيحي بمأمن من الخوف من الموت، فليس في الخبرة المسيحية من مبرر لهذا الاعتقاد:
1 – فالإيمان لا ينتزع الإنسان من مأساة وضعه ووجوده، تلك المأساة التي تبلغ بالموت ذروتها. ذلك أن الإيمان، وإن كان يجعل بين الله والإنسان علاقة وألفة، إلا أنه لا يلغي بالكلية غربة الإنسان. ذلك أن الإيمان يختلف عن الرؤية: “أما وجهي، يقول الله لموسى، فلا تستطيع أن تراه لأنه لا يراني إنسان ويعيش” (خروج 33: 20) . لذا يقول الرسول بولس: “فنحن اليوم نرى في مرآة رؤية ملتبسة، وأما يومذاك فتكون رؤيتنا وجهاً لوجه…” (1 كو 13: 12)؛ وأيضاً: “عالمين أننا، ما دمنا مقيمين في هذا الجسد، نظل في دار غربة عن الرب، لأننا نهتدي بالإيمان لا بالعيان…” (2 كو 5: 1-7).
2 – لا بل أن الإيمان، بمعنى من المعاني، يجعل الإنسان أكثر تحسساً لمأساة الوجود. إذ لا بدّ أن يؤمن المرء، إلى أبعد حدّ، بالحياة والفرح، إذا آمن بالله الذي هو حياة كله وفرح كله وينبوع دائم التدفق للحياة والفرح. لذا فالمؤمن، من حيث هو ابن للنور، شديد الحساسية لكل ما يشاهده ويختبره من ظلمات في الأرض. إنه، من حيث انتمائه إلى إله الحياة والفرح، مرهف الحساسية لكل ما يراه مناقضاً لذلك الإله في الوضع الترابيّ الراهن الذي يعيشه، أي لكل بؤس وشقاء وموت. وبما أنه اتخذ ملكوت الله، أي ملكوت الحياة الظافرة، موطناً له، فإنه، من جراء ذلك، أكثر إحساساً من سواه – أو هكذا يُفرض على الأقل – بعناصر غربته عن هذا الوطن، وهي عناصر تتلخص وتتبلور في الموت، ذلك الموت الذي هو، بظاهره، ذروة الفشل واللامعنى.
في مقابلة أجراها معه كريستيان شابانيس، يوضح رئيس أساقفة باريس الكاثوليكي، جان ماري لوستيجر، أنه أهون على غير المؤمن أن يرضخ للأمر الواقع فيقبل بفنائية الإنسان كتعبير عن محدوديته، وأن هذا الموقف لا يخلو من نبل لأن فيه حكمة وإتضاعاً. “أما الذي يكتشف أن الله حياة وينبوع حياة، فعثرة الموت أعظم في عينيه. بمقدار ما يذوق الإنسان عظمة الحياة الممنوحة من الله، بهذا المقدار تبدو له عثرة الموت هائلة…” .
3 – ثم إن الموت، بنظر المؤمن، ليس مجرد انقطاع العلاقات التي تربطه بالأرض وبالناس، إنما هو أفدح وأدهى من ذلك، لأنه، بمعنى من المعاني، انقطاع لعلاقته بالله، تلك العلاقة التي يجد فيها كمؤمن قلب وجوده ومحور هذا الوجود ومبرّره. ذلك أن الموت يشكّل انقطاعاً لتلك العلاقة من حيث النمط الذي تتخذه في الوجود الأرضيّ، وهو النمط الوحيد الذي تعرّف إليه المؤمن واختبره وألِفه، ولم يألف سواه لا بل لا يسعه حتى أن يتصور سواه. يقول المفكر المسيحي اينياس ليبّ:
” لا تكاد توجد لدينا أية وسيلة لنعرف بالتأكيد مما تتكون بالضبط هذه الحياة الأخرى التي نحن سائرون إليها (…) إن الكتب الموحاة متكتمة إلى أقصى حدّ حول هذا الموضوع (…) صحيح أنه يحق لنا أن نرجو أن الحياة الأبدية ستحقق ملء أمانينا، إنما كيف وبماذا، فهذا ما نكاد نجهله بالكلية”.
هذا ما عبّر عنه الروائي المسيحي الفرنسي الكبير فرنسوا مورياك في بعض مذكراته، عندما كتب:
” أعترف أن الأمر يختلف بين الإيمان بالحياة الأبدية وبين تصوّرها. إنه لا يسعني أن أتخيل، أن أتصور ما أعتقده لأنه يتخطى المفاهيم البشرية”.
وقد أضاف في موضع آخر:
” الموت لن يعني بالنسبة إلينا مغادرة الأرض وحسب، إنما أيضاً مغادرة السماء كما حظينا بها في الجسد، ولو كان ذلك في ذلّ الخطيئة ودموعها” .
4 – مثال يسوع:
إن ما سبق يتأكد لنا إذا تأملنا في موقف يسوع – وهو المثال الأعلى للمسيحي – حيال موته الشخصيّ، وهو موقف يزداد وضوحاً إذا أجرينا مقارنة بينه وبين سقراط في وضع مماثل. وقد أجرى هذه المقارنة العالم الكتابيّ السويسري الكبير أوسكار كولمان ، واستشهد بتحليله هذا اللاهوتي الكاثوليكي الإسباني ج. م. غونزاليز – رويز في كتابه “الإيمان بعد ماركس” .
سقراط يواجه الموت بصفاء كلّي. إنه لا يخشاه بل يرى فيه الصديق الحنون، لأنه يعتقد أن فعل الموت يقتصر على تحرير نفسه من سجنها الترابيّ. أما يسوع فانه يبدي رهبة حيال الموت لم يخفها عنا الإنجيليون. ليس في هذه الرهبة أثر للجبن. فيسوع يتجه إلى أورشليم بخطى ثابتة وهو عالم بالمصير الذي ينتظره فيها:
•”وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم، وكان يسوع يتقدمهم، وكانوا هم منذهلين، والذين يتبعون خائفين. وعاد فاعتزل بالإثني عشر، وطفق يقول لهم ما سيجري له: “ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن البشر سيسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت…” (مرقس 10: 32 – 33).
•” وفي تلك الساعة تقدم إليه نفر من الفريسيين، وقالوا له: “إنطلق! اذهب من ههنا، فإن هيرودوس يريد أن يقتلك”. فقال لهم: “اذهبوا، وقولوا لهذا الثعلب: ها أناذا أطرد الشياطين، وأجري الأشفية، اليوم وغداً؛ وفي اليوم الثالث ينقضي أجلي! ولكن، لا بدّ من أن أواصل الســير اليـوم وغـداً ومـا بعـده؛ إذ لا يليــق أن يهلك نبي خارج أورشليم!…” (لوقا 13: 31-32).
يسوع يواجه إذاً الموت بتصميم كامل تتميماً لرسالته ومحبةً للآب والناس، ولكنه يستفظع الموت لأسباب تتعدى بكثير مجرد غزيرة البقاء. فالموت بالنسبة له (كما بالنسبة لكل التراث اليهودي الذي كان يحمله) انقطاع عن الله، سيد الحياة ومصدرها:
•”… مثل القتلى الذين في القبور يرقدون الذين لا تذكرهم من بعد وهم عن يدك مُقصون”.
(مزمور 87: 5)
•”… أيخبر أحد في القبر برحمتك؟ وفي مكان الهلاك بأمانتك؟ أتُعرف في الظلمة عجائبك؟ وفي الأرض المنسية عدالتك؟”
(مزمور 87: 11و 12)
فالموت، بالنسبة للتراث اليهودي، وليسوع المغتذي من هذا التراث، عدوّ الله، إنه “العدوّ الأخير” (1كو 15: 26). وبالتالي، فقد كان من الطبيعي أن يعاني يسوع من جراء وقوعه بين براثنه أكثر من أي شخص آخر، بسبب العلاقة، الفريدة في عمقها ووثاقتها، القائمة بينه وبين الآب (“قد أولاني أبي كل شيء، فما من أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا من أحد يعرف الآب إلا الابن ومن شاء الابن أن يكشف له”، متى 11: 27). لقد كان الموت غريباً عن يسوع كل الغرابة بسبب الإلفة التي لا مثيل لها القائمة بينه وبين سيد الحياة (“أنا والآب واحداً”، يوحنا 10: 30)، لذا كان من الطبيعي أن تبلغ معاناته من الموت ذروتها. من هنا الكآبة التي استحوذت عليه قبل تسليمه في بستان الجسمانية:
•”ثم مضى ببطرس ويعقوب ويوحنا، وجعل يستشعر رهبة وكآبة. فقال لهم: “نفسي حزينة حتى الموت…”
(مرقس 14: 33 و34)
من هنا صيحته المأساوية على الصليب عندما هتف بعبارة المزامير:
•”إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟”
(مزمور 21: 1 و مرقس 15: 34)
إلا أنه، في تلك اللحظة التي اكتنفت فيها كيانه ظلمة دامسة أطبقت على جسده النازف المختنق ونفسه المسحوقة تحت وطأة الظلم والكراهية والنبذ والفشل والعزلة، في تلك اللحظة الرهيبة التي بدا له فيها وكأن الله نفسه قد تخلّى عنه وكأن الكلمة الأخيرة بقيت للموت عدوّ الله، لبث يسوع راسخاً، رغم كل شيء، في ثقته بالآب وبتقبل الآب له، كما يظهر من ندائه الأخير الذي يرويه الإنجيلي لوقا:
•” يا أبتاه، في يديك أجعل روحي!”
(لوقا 23: 46).
ذلك “أن اللامعنى كان له أيضاً في نظره معنى خفيّ وأخير “. وقد جاءت القيامة تكشف هذا المعنى أمام الملأ وتعلن صحة رجاء يسوع.
5 – شهادة الرسول بولس:
كذلك نرى الرسول بولس يبيّن (ملمّحاً كما يبدو إلى خبرة شخصية) كيف أن الإيمان بالقيامة لا يلغي جزع الموت، وكيف أن المسيحي يتمنى لو أنه يستطيع أن يبلغ القيامة دون المرور بمعاناة الموت:
•”ونحن نعلم أنه إذا هُدم بيتنا الأرضي، وهو أشبه بالخيمة، فلنا في السموات بيت من بناء الله لم تُشِدْه الأيدي، وإنا نئنّ حنيناً إلى لبس هذا المسكن السماويّ فوق ما نحن عليه، إذا قُدّر لنا أن نكون لابسين لا عراة. ولذلك نئنّ مثقلين ما دمنا في هذه الخيمة، لأنا لا نريد أن نخلع ما نلبس، بل نريد أن نلبس ذاك فوق هذا …”
(2 كو 5: 1 – 4)
رابعاً: الإيمان المسيحي يعطي للموت معنى ولكنه لا يلغي رهبته بل يجعل في قلب المؤمن ثقة بالله لا تقوى هذه الرهبة على زعزعتها.
1- فالإيمان ليس الرؤية، ولكنه نور في ظلام الوجود، ويمكن أن نقول عنه ما يقوله الرسول بطرس عن كلام الأنبياء:
“كأنه مصباح يضيء في مكان مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويشرق كوكب الصبح في قلوبكم”.
(2 بطرس 1: 18)
المفارقة التي يعيشها المؤمن هي اختباره بأنه لا يزال في عالم الموت ولكنه قد تخطاه بآن. هذا ما يذكرنا به اللاهوتي الألماني المعاصر والشاهد الأمين حتى الموت للإنجيل حيال الطغيان الهتلري (فقد أُعدم شنقاً سنة 1945، ولم يكن يتجاوز التاسعة والثلاثين من عمره، بأمر من السلطات النازية التي قاوم بشجاعة دوسها للقيم الإنسانية). يقول بونهوفر:
“… لا تزال الإنسانية تعيش، على وجه التأكيد، في العالم القديم؛ ولكنها تخطّته منذ الآن؛ لا تزال تعيش في عالم الموت، ولكنها منذ الآن قد تجاوزت الموت؛ لا تزال تعيش في عالم الخطيئة، ولكنها منذ الآن قد تجاوزت الخطيئة. لم ينقضِ الليل بعد، ولكن الفجر منذ الآن قد بدأ يلوح ”
2- يبقى الموت إذًا بنظر المؤمن هذه الكارثة التي ينهار فيها مجمل كيانه البشري، من جسد ووجدان، ولكن قبوله لواقع هذا الانهيار واسطة ومحكّ لتجرّده من كلّ ادّعاء ذاتيّ ولإسلامه الكلّي لله الذي ينتظر منه ومنه وحده أن ينتشله من هوة الزوال، إذ لا يستطيع أن يركن في سبيل ذلك إلى طبيعته الذاتية، وكأن الخلود مسجّل فيها بالاستقلال عن الله وعن علاقتها به. إن ثقة المؤمن بالغلبة على الموت تستند، لا إلى خلود طبيعي مزعوم يتمتع به حسب اعتقاد الإغريق، بل إلى تحقّقه – عير إيمانه بقيامة المسيح واختباره لهذه القيامة في حياته – بأن الله أمين على محبته للإنسان وعلى علاقته به، حتى ولو اجتاز الإنسان كارثة الموت.
لقد سأل كاتب المزمور 87 بجزع:
“أيخبر أحد في القبر برحمتك؟ وفي مكان الهلاك بأمانتك؟”
(مزمور 87: 11)
وعليه يجيب الرسول بولس:
“وما أصدق هذا القول: “إن نحن متنا معه، فسنحيا معه، (…) فهو يبقى أميناً، لأنه لا يقدر أن ينكر ذاته”.
(2 تي 2: 11 و13)
ويهتف الرسول نفسه في مكان آخر معلناً:
“إنّي واثق بأنّه لا الموت ولا الحياة (…) ولا شيء بوسعه أن يفصلنا عن محبة الله لنا في ربنا يسوع المسيح”.
(رومية 8: 35 و38)
وكأنه يرجّع صدى تأكيد السيّد:
“فخرافي تسمع صوتي، وأعرفها فتتبعني وأنا أهب لها الحياة الأبدية، فلا تهلك أبداً ولا يختطفها أحد من يدي. إن الآب الذي وهبها لي أعظم من كل موجود. ما من أحد يستطيع أن يختطف من يد الآب شيئاً. أنا والآب واحد”.
(يوحنا 10: 27-30)
3- لا بل إن المؤمن يعترف أن انهيار كيانه البشري الراهن بالموت، بكل ما يفترضه هذا الانهيار من معاناة، شرط لا بدّ منه لكي تبرز فيه حياة جديدة بالكلية (“ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبونه”، 1 كو 2: 9) يكتمل بها حضور الله فيه. فلا بدّ من انحلال الوضع البشري الراهن كي يولد الوضع الجديد. لا بدّ من تفكّك الكيان البشري الحاضر ليزول بتلاشيه الموت والفساد الملازمان له ولكي بزوالهما تنتصر الحياة نهائياً فيه، “فيلبس هذا الكائن الفاسد عدم الفساد، ويلبس هذا الكائن المائت الخلود” ( 1 كو 15: 53). الإيمان المسيحي هو إذاً إيمان بأن الحياة تنتصر على الموت إنما عِبْرَ مرورها بالموت (كما أن المسيح “وطئ الموت بالموت”).
هذا التحوّل الذي يتمّ عبر انحلال الكيان الأرضيّ الراهن بالموت، يوضحه الرسول في المقطع التالي الذي لا بدّ، إن شئنا أن نفهمه على حقيقته، من التذكر بأن عبارة “الجسد” فيه (كما في الكتاب المقدس عامة) تشير إلى الكيان الإنساني برمته:
” وربّ قائل يقول: “كيف يقوم الأموات وفي أي جسد يعودون؟” يا لك من جاهل! ما تزرعه أنت لا يحيا إلا إذا مات. وما تزرعه هو غير الجسم الذي سوف يكون (…) وإن الله يجعل (له) جسماً كما يشاء …”.
(1 كو 15: 35 – 38)
لا بدّ إذاً من أن ينحلّ كياننا الترابيّ الراهن كي نكتسب الشفافية اللازمة لتقبّل الكيان الجديد الذي يمنحنا الله إياه والذي لا سلطان للموت عليه. الموت، من هذا القبيل، يصبح “فصحاً” (فكلمة “فصح” تعني عبوراً كما هو معروف)، لأنه عبور من الفناء إلى الخلود، من الغربة إلى الاتحاد. ولكن هذا العبور لا يتمّ إلا عبر كارثة (شبيهة بكارثة الصليب)، كارثة انهيار كياننا العتيق ليبرز على أنقاضه كياننا الجديد المتجلي.
4- هكذا فالإيمان المسيحي يجمع إلى أخذ الموت ورهبته على محمل الجدّ، ثقة بالله لا تقوى هذه الرهبة على زعزعتها:
يقول ديتريش بونهوفر:
” إن الإيمان بالقيامة ليس “حلاًّ لمشكلة الموت”
وهذا صحيح لأن المشكلة لا تلغى إنما تُطرح بشكل مختلف جذرياً ومن زاوية جديدة بالكلية.
ويقول بيار تاليك:
“القيامة انتصار على الموت، ولكن الموت ليس بحكم الملغى” .
صحيح أن الموت بمعناه المطلق، بمعنى الزوال والفناء، لم يعد له وجود بنظر المؤمن. بهذا المعنى قال السيد:
“من يحفظ كلامي لا يَرَ الموت أبداً”
(يوحنا 8: 51)
وأيضاً:
“من يحيَ مؤمناً بي لا يمت أبداً”
(يوحنا 11: 26)
بهذا المعنى كان أحد كبار الروحيين البيزنطيين يقول:
“أعرف أنني لن أموت، لأنني أشعر بأن الحياة كلها تتفجر في داخلي” .
ولكن هذا اليقين الإيماني لا يلغي ضرورة الموت كعبور مأساوي وزلزلة كيانية. من هنا نفهم ما عبّرت عنه مادلين دلبريل، التي عاشت بعد اهتدائها إلى المسيح بهاجس الشهادة له بين الملحدين، والتي كان لها إحساس ذاتي مرهف برهبة الموت، بقولها:
” إنه (أي المسيحي) يعتقد أنه (أي الموت) يبقى رهيباً ولكنه ليس خالياً من معنى” .
5 – إن هذا الموقف الإيمانيّ من الموت، الذي ينزع عنه طابع اللاشفافية المطلقة، أي اللامعنى، ولكنه يعتبره بآن معاً انقطاعاً جذرياً عن نمط الحياة المألوف لدينا ، هذا الموقف يحفظ لكل من الحياة الحاضرة والحياة الآتية حقهما. فالحياة الحاضرة تستمد قيمتها من الشعور بأنها نمط من الحياة فريد يمضي إلى غير رجعة ولن يتكرر. أما الحياة الآتية، فتظهر على حقيقتها إذا اعتُبرت على أنها حياة أخرى بالكلية وليست بمثابة امتداد لامتناه للحياة الراهنة .
هكذا لا ينساق المؤمن إلى اعتبار الحياة الأخرى نوعاً من البديل عن الحياة الحاضرة ومدعاة إلى الهروب من مواجهة مشاكل الدنيا. إنما يعتبر الحياة الأرضية هبة من الله فريدة، ويتجند بالتالي لمكافحة قوى الموت الفاتكة بها على أنواعها (من بؤس ومرض وألم وقهر وظلم وأنانية واستئثار …)، ويدعمه ويشدد عزائمه في مسعاه هذا يقينه بأن جهاده في سبيل انتصار الحياة على الموت فيه وحوله إنما هو مشاركة في عمل الله الخلاصي سيُكتب لها الظفر في آخر المطاف، إنما بنمط يستحيل تصوّره، في العالم الأخرويّ القياميّ الذي يعيش تباشيره منذ الآن ولكنه لن يَلِجُه كلياً إلا عبر محنة كيانية يفقد فيها ذاته ليجدها بهية خالدة في الله. لذا فمن الطبيعي أن يرهب المسيحي محنة الموت هذه وإن كان يواجهها بثقة عميقة وقلب عامر بالرجاء.
6- بقي أن نشير إلى أن المؤمن، إذا عاش إيمانه تغليباً مستمراً لهاجس التواصل والمشاركة والعطاء على نزعة الأخذ والتملك والاستئثار، فإنه يندرج في سياق تجاوز مستمر لذاته وإعراض عن التشبث بأي شكل من أشكال الاستملاك، بما فيها امتلاك حياته. من يتشبث بما يملك كان فريسة الخوف من فقدانه. أما من اختبر أن غنى الوجود وحريته وفرحه إنما هي في المشاركة والعطاء (“السعادة الكبرى في العطاء لا في الأخذ”، أعمال 20: 35)، فقد حصل على اطمئنان عميق يسهّل عليه، إلى حدّ ما، أن يقبل بفقدان ما ملكت يداه، وأن يرتضي، في آخر المطاف، التعرّي الكامل بالموت من ملكية ذاته.
3/4/1985
ك.ب.
مجلة “النور”، العددان 4و5